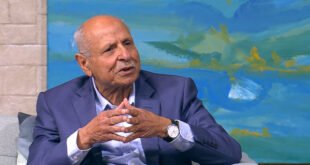الاول نيوز – محمد قاسم عابورة –
الموازنة العامة للدولة ليست مجرد بيان مالي وجداول ارقام ، فهي المرآة العاكسة لخياراتها السياسية وأولوياتها الاقتصادية ، ولتوازنات القوى داخلها ، وفي ظل التحديات البنيوية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني .. من بطالة مستعصية وخدمة دين ثقيلة واعتماد على المساعدات .. تتحول موازنة عام 2026 من وثيقة رقمية روتينية إلى المحك الذي يُختبر من خلاله الإرادة الإصلاحية ، و يكشف عن الإشكالية التي تواجه مسيرة التنمية ، والتي لا تقتصر على نسب العجز أو النمو، بل تتجاوزها إلى أزمة منهج وطريقة تفكير ، من حيث استمرار مسارات التسيير قصير المدى ، على حساب التخطيط الإستراتيجي نحو تشكيل المستقبل وبناء اقتصاد منتج وقادر على الصمود .
إنّ القراءة المتأنية لبنود الإيرادات والنفقات تكشف أن هذه الموازنة ، رغم الخطاب الطموح ، تعمل وفق آلية إدارة الأزمة وتأبيد الواقع ، فهي تقدم السياسات التي أنتجت الأزمات ، و تعيد إنتاج نفس المنطق من إسراف في النفقات الجارية ، على حساب الاستثمار المنتج ، والإعتماد على الضرائب غير عادلة ، والتي تثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة ، والإستسلام لعبء الدين كقدر محتوم بدلاً من معالجته كخيار سياسي :
أولاً : تضخم النفقات الجارية وغياب البعد التنموي
لا تزال الحكومات المتعاقبة تتعامل مع إعداد الموازنة بمنطق الترقيع والتعديلات الهامشية ، حيث يقتصر الاختلاف عن السنوات السابقة على تغييرات طفيفة في أرقام الآحاد أو العشرات ، دون مساس بالهيكل الأساسي ، فما زالت الموازنة رهينة منطق تسيير الأعمال بدلاً من قيادة التنمية ، حيث تستأثر النفقات الجارية بنسبة 87.7% من إجمالي الإنفاق ، وهي نسبة تكاد تكون مطابقة لنظيرتها في عام 2025 (88.3%) ، إن هذا الاستمرار ليس مجرد مؤشر رقمي ، بل هو تعبير عن عجز بنيوي في التخطيط الاستراتيجي ، بموجبه تُوجه الأموال بشكل شبه كامل لتمويل الرواتب (6.6 مليار دينار) وخدمة الدين العام (2.260 مليار دينار). .
صحيح أن هناك زيادة هامشية في النفقات الرأسمالية (1.6 مليار دينار مقابل 1.469 مليار) ، إلا أن الجزء الأكبر منها موجه لتمويل مشاريع قائمة ، والأخطر من ذلك ، أن القيمة الحقيقية لهذا الإنفاق التنموي تتآكل بفعل التضخم ، مما يحول دون تحقيق أي تحول نوعي قادر على معالجة إشكاليات البطالة والتضخم بشكل جذري ، وبهذا تبقى الموازنة أداة لـ”إدارة الوضع القائم ” وليست محركاً للتغيير .
ثانياً : الدين العام .
يبقى الدين العام، والذي بلغ قرابة 119% من الناتج المحلي الإجمالي ، عبئاً ثقيلاً يخيم على كل القرارات الاقتصادية ، وتعلن الحكومة عن هدف طموح لخفض هذه النسبة بنهاية 2026، غير أن هذا الهدف غيرواقعي و محفوف بالمخاطر ، لأنه يستند إلى فرضيات هشة ، أبرزها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.9% وتأمين المنح الخارجية المتوقعة ، وإن أي تراجع في تحقيق هذه الفرضيات ، وهو أمر مرجح في بيئة اقتصادية غير مستقرة، سيدفع النسبة للارتفاع التراكمي والمستمر .
إنّ تكلفة خدمة هذا الدين (2.26 مليار دينار) ليست بند محاسبي فقط ، إنما هي استنزاف لرأس المال الوطني ، وإن هذا المبلغ الضخم ، والذي كان من الممكن توجيهه لتمويل مشاريع بنية تحتية حيوية أو تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية ، يذهب بدلاً من ذلك لسداد التزامات متراكمة لسياسات الحكومات السابقة ، وهذه الآلية تعكس أزمة حقيقية في ترتيب الأولويات، حيث يتم تجميد الاستثمار في المستقبل لتمويل الإرث الماضي .
ثالثا : العجز في الموازنة ووهمية الحلول..
يصل العجز في الموازنة إلى 2.125 مليار دينار، وهو ليس مجرد رقم محاسبي عابر، بل هو تجسيد لأزمة المنهج التي تعاني منها السياسة المالية ، والسؤال الجوهري الذي تتفاداه الحكومات هو: كيف سيتم تغطية هذا العجز؟ فالحلول التقليدية المطروحة هي إما زيادة الأعباء الضريبية على المواطن المستنزف أصلاً ، مما يعمّق أزمة العدالة الاجتماعية ، أو من خلال اللجوء إلى قروض جديدة ، وهذا يؤدي الى تراكم على الدين العام الذي تجاوز الحدود الآمنة ، وهذا الخيار يعني حتماً زيادة متصاعدة في خدمة الدين ، ليصبح جزءا أكبر من إيراداتنا المستقبلية محجوزاً مسبقاً لسداد فوائد هذا الدين .
إن الاستمرار في هذا النهج الاقتراضيّ ، يبقينا في حلقة مفرغة ، تلتهم مستقبل الأجيال القادمة ، وهو مقامرة خطيرة بسيادة الدولة واقتصادها ، حيث يتحول العجز من مشكلة مالية مؤقتة إلى أزمة بنيوية دائمة ، تُدار من خلال تأجيلها وتراكمها ، بدلاً من معالجتها ، وهكذا تتحول الموازنة من أداة لتخطيط المستقبل إلى آلية “لإدارة الأزمة“، تُركز على تمويل العجز الآني على حساب النخطيط لبناء مستقبل منتج ومستقر .
رابعاً : التضخم والبطالة ..
تمثل السيطرة على التضخم (المستهدف 2.7% في 2026) إنجازاً تقنياً لا يمكن إنكاره ، لكن هذا الإنجاز تتعارض نتائجه مع هيكل الإيرادات المعتمد ، فاعتماد الموازنة على الضرائب غير المباشرة بنسبة تتجاوز 70% يضع العبء الأكبر على كاهل المواطن عبر ضرائب الاستهلاك ، مما يلتهم القوة الشرائية التي من المفترض أن يحافظ عليها انخفاض التضخم ، وهنا تظهر المفارقة ، وهي وجود سياسة نقدية تكافح التضخم ، وسياسة مالية تزيد من الأعباء المعيشية عبر نظام ضريبي غير عادل .
تُعَد مُشكلة البطالة ، والتي تتجاوز نسبتها 21٪ ، إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ، ومع ذلك، تظل الحلول المُقترحة في الموازنة العامة غير كافية لمواجهة هذا التحدي ، حيث تُظهِر الموزنة إخفاقًا واضحًا في استيعاب المشاريع الإنتاجية الحقيقية والقادرة على خلق فرص عمل مستدامة ، فالمبالغ المخصصة تبقى محدودة الأثر، ولا تُشكّل ميزانية حقيقية لمكافحة البطالة ، بل تتوجه نحو برامج تنموية عامة تفتقر إلى التركيز الكافي على القطاعات الإنتاجية ذات الأثر الملموس في سوق العمل
هذا القصور لا يعكس فقط عدم تناسب حجم التخصيصات مع حجم الأزمة ، بل يُظهر أيضًا غياب خطة وطنية متكاملة وممنهجة لمعالجة البطالة ، فالنفقات الرأسمالية المحدودة لا يمكنها وحدها خلق الحجم المطلوب من الوظائف المستدامة ، وهذا يؤكد غياب رؤية استراتيجية لمعالجة هذا الملف الحيوي ، والذي يمس صميم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويهدد بتفاقم الأوضاع في ظل غياب مشاريع إنتاجية حقيقية قادرة على امتصاص البطالة وتحفيز النمو .
خامساً : المناخ الاستثماري
تُقدّم الموازنة خطاباً متفائلاً حول تحسين المناخ الاستثماري ، يتجسد في زيادة مخصصات التسويق بنسبة 18.4% وإطلاق خريطة استثمارية جديدة ، إلا أن هذا الخطاب يصطدم بحائط الواقع ، حيث تكشف القراءة عن فجوة تحليلية بين الحلول الترويجية من جهة ، وجوهر الإشكاليات الرئيسية من جهة أخرى ، فالتقارير المحلية والدولية تُجمع على استمرار معوّقات أساسية لم تُعالج ، كالروتين والبيروقراطية المعقدة وعدم استقرار التشريعات ، وارتفاع كلف الإنتاج الأساسية كالطاقة والمياه ، وضعف التنسيق بين المؤسسات .
إن هذه الفجوة بين المخصصات المالية والمعضلات البنيوية ، تجعل من الصعب ترجمة الطموحات إلى استثمارات فعلية على الأرض ، وتحوّل البرامج الترويجية إلى مجرد “صرخة في واد“، حيث تبقى الاستثمارات الحقيقية حبيسة التنظير بعيدةً عن التطبيق ، بمعنى آخر، يتم استثمار الأموال في تسويق بيئة استثمارية غير جاهزة ، مما يُنتج حالة من الإنكفاء عن الإستثمار ، وخلق بيئة طاردة ، حيث تتهرب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من دائرة الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي إلى قطاعات طُفيلية أو أسواق خارجية أكثر أماناً واستقراراً ، لذلك فإن معضلة المناخ الاستثماري لا تكمن في ضعف التسويق ، بل في غياب الإرادة والإصلاح المؤسسي ، والتخطيط الإستراتيجي القادر على تحويل الخطاب الطموح إلى واقع ملموس .
يقودنا التقييم الموضوعي لموازنة 2026 إلى حقيقة جَوهرية مفادها أن هذه الجداول المالية ، على الرغم من مُحاولاتها إظهار الانضباط والكفاءة المالية ، تظلُّ أسيرة النموذج التقليدي الذي أظهر عجزه عن تحقيق أي تقدم أو نقلة نوعية ، فبدلاً من أن تمثل قطيعة استراتيجية مع منطق “إدارة الأزمات ” ، نجدها تُعيد إنتاج نفس الأزمات ، وتولد منها أزمات جديدة ومركّبة .
إن هذا الواقع يفرض ضرورة الانتقال من ثقافة “القص واللصق ” ، “وتلبيس الطوقي ” وسياسة ” “كل يوم بيومه” ، إلى فكر “التخطيط الاستراتيجي”، وهو ما يتطلب جرأة سياسية تترجم إلى برنامج إصلاحي متكامل يقوم على أربعة أركان :
1 – إعادة هيكلة جذرية للإنفاق : خفض تدريجي وحاسم للنفقات الجارية غير الإنتاجية ، ورفع حصة النفقات الرأسمالية إلى 20% على الأقل من إجمالي الموازنة ، على أن تُوجَّه هذه الاستثمارات حسب الأولويات نحو مشاريع إنتاجية ذات عائد تنموي مرتفع وقادر على خلق فرص عمل مستدامة .
2 – إصلاح ضريبي عادل: يجب التحول من النظام الضريبي القائم على الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة ، إلى نظام ضريبي تقدمي يرتكز على الضرائب التصاعدية المباشرة على الدخل والثروة ، وهذا التحول ليس مجرد مسألة فنية ، بل هو مدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تمويل مستدام للموازنة .
3 – زيادة الإيرادات غير الضريبية: تأتي زيادة الإيرادات غير الضريبية ، من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المُستغلة ، وإدارة ممتلكاتها بشكل كفؤ وقادر على تحقيق إيرادات مستقلة ، وهذا التوجه يُشكّل ضمانةً ضد التقلبات في الإيرادات الضريبية والمنح الخارجية ، ويُعزز سيادة الدولة في سياساتها المالية .
وأخيراً، لا قيمة لأي إصلاح دون ربط التمويل بالنتائج ، عبر تحويل الصرف الحكومي من كونه مجرد تنفيذ للإعتمادات إلى استثمار خاضع لمعايير الكفاءة والفعالية الإنتاجية ، و ربط كل صرف بمؤشرات أداء واضحة ، مع تطبيق آليات رقابية صارمة وإصدار تقارير دورية شفافة تقيس الأثر الحقيقي للموازنة على حياة المواطن ومؤشرات الاقتصاد الكلي ، والموازنة العامة هي صورة من صور العقدٌ الإجتماعي ، تُحدد بموجبه أولويات الحاضر واستثمارات المستقبل ، مما يحولها من وثيقة محاسبية إلى عقد أداء بين الحكومة والمواطن .
إن الموازنة في نهاية المطاف ليست مجرد أرقام وجداول ، بل هي تجسيد لإرادة سياسية واختبار لجدوى الخيارات الاقتصادية ، ولا يقاس النجاح بمجرد إعداد ميزان أرقام حسابيا ، بل السير باتجاه التغيير ، والإنتقال من سياسات “الترقيع” الضيقة إلى سياسات التخطيط الإستراتيجي للمستقبل ، وعندما تفتقر الموازنة إلى الرؤية الاستراتيجية ، أو الجرأة الإصلاحية ، فإنها تتحول من أداةٍ للتغيير والبناء إلى آليةٍ لتجميد وتأبيد الواقع وإعادة إنتاجه .